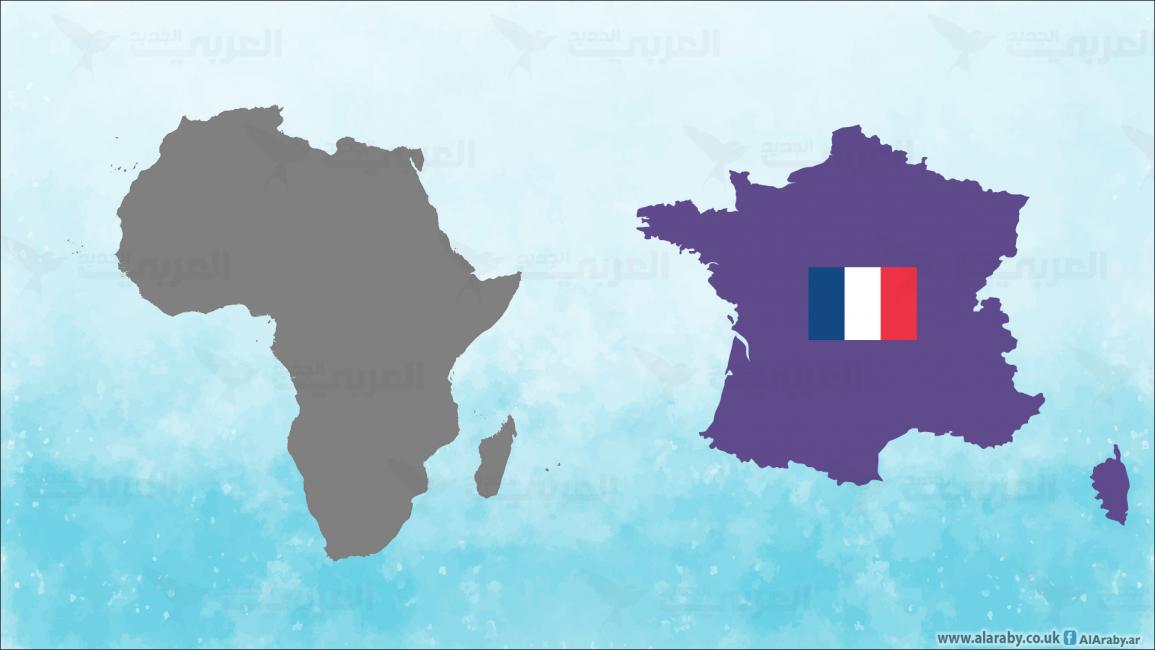السيـــاق:
في السنوات الأخيرة عرفت علاقة فرنسا بمستعمراتها الأفريقية توترا ملحوظا؛
وصل للقطيعة في بلدان عديدة، واكتفى بالبرودة في بلدان أخرى، قادته النخبة
العسكرية، عبر انقلابات ناجحة، في بعض البلدان، وتبنّته بعض الشعوب، عبر
صناديق الاقتراع والخطب السياسية، في بلدان أخرى؛ مما يجعل المتابع يخيل
إليه أن الأمر يتعلق ببعد استراتيجي تُجمع عليه نخب غرب أفريقيا مع شعوبها.
في هذه المقالة، سنحاول استعراض طبيعة تصدع جسور التواصل الغرب أفريقي
الفرنسي وأسبابها، وهل الأمر يعود لقرار استراتيجي، تتبناه النخب والشعوب
معا؛ أم أن الأمر مجرد تكتيك تستغله النخبة لتبرير السطو على السلطة، أحيانا،
كما هو الحاصل في مالي، واستثمار لعاطفة الشعب للحصول على ثقته؛ مثلما
حصل في السنغال.. سنتناول الموضوع من خلال نموذجي مالي والسنغال؛ مع
محاولة الفصل منهجيا بين الأسباب والدوافع؛ ومن ثم النتائج!
مالي من فرنسا إلى فاغنر:
بعد الانقلاب على حليف فرنسا المقرب إبراهيم بوبكر كيتا من طرف الكولونيل
أسيمي غويتا عرفت العلاقة مدا وجزرا قويا؛ إلا أن تنصيب باه انضو من قبل
الانقلابي وزملائه كاد أن يعيد المياه إلى مجاريها بين فرنسا و”سودانها” غير أن
انقلاب “غويتا” الثاني على انضو كان القشة التي قصمت ظهر البعير؛ إذ
سرعانما أعلنت فرنسا تعليق العمليات العسكرية المشتركة مع الجيش المالي؛
لتوقفها، بعد ذلك، قبل أن تسحب قواتها.
وقد رأى الكولونيل في سلوك فرنسا طعنة من الخلف؛ فأخذ يبحث لنفسه ونظامه
عن طوق نجاة، مشرقا ومغربا؛ فهو في وضع لا يحسد عليه؛ إنه محاصر
بالكثير من الأعداء؛ أولها الشرعية التي أطاح بها مرتين، وثانيها النخبة
السياسية؛ التي وقفت ضده، رافضة انقلابه، وثالثها المتمردون والخارجون على
الدولة، من فصائل “الفولان” و”العرب” و”الطوارق” و”الإرهابيين” ورابعها
المحيط الإقليمي؛ حيث قررت مجموعة “إيكواس” فرض حصار متدرج وشامل
على دولة مالي.
كان الكولونيل أسيمي غويتا مستعدا للتحالف مع الشيطان، من أجل مواجهة هذا
الواقع الصعب، وكانت روسيا، بعد أن تنفست الصعداء في سوريا، تتوق إلى
فتوحات جديدة، وقد كان صراعها، مع الغرب، ممتدا في العديد من البلدان؛ مثل
سوريا وليبيا.. لذلك كانت ترغب في تمطيط لعبة الشطرنج؛ حتى تجد منافذ على
مناطق أخرى؛ لقد كانت عينها على غرب أفريقيا؛ بعد أن وجدت موطئا في
شمالها؛ من هنا تلاقت أطماع قيصر روسيا مع احتياجات كولونيل مالي.
هكذا، نرى أن الأمر لا علاقة له ببعد استراتيجي؛ وإنما هو مجرد موقف أملته
الظروف وفرضته المصالح؛ فالنخبة المالية -بما فيها النخبة العسكرية- نخبة
فرنسية الهوى والتكوين والتفكير؛ لكن فرنسا لم تترك للشاب غويتا خيارات
كثيرة؛ خصوصا أن مبرراتها، المتمثلة في احترام الشرعية، ليست مستساغة
كثيرا في مالي، ولا في المنطقة عموما، إذ يرى الكثير من نخب أفريقيا أن فرنسا
كانت -في الغالب الأعم- الراعي الأول للانقلابات في أفريقيا؛ فلماذا انقلاب
غويتا وحده الذي ترفضه فرنسا!
إنه سؤال وجيه، خصوصا حين نستعيد تاريخ الخروج على الشرعية في غرب
أفريقيا، وموقف فرنسا منه؛ إذ لم يسبق، قبل ما حدث في مالي، أن أعادت فرنسا
الشرعية في أي دولة غرب أفريقية، كما لم يسبق لعلاقاتها أن تضررت، بهذا
الشكل، مع دولة من غرب أفريقيا بسبب الخروج على الشرعية.
وعلى ترنح النظام المالي الحالي، وعلى ما يعيشه من أزمات داخلية؛ أقلها أن
سطوة المتمردين تزداد ورقعتهم تتوسع، ورغم إدراك الماليين، أنهم اختاروا
حليفهم في الوقت الغلط؛ إذ أن روسيا مرهقة بالملف الأوكراني؛ رغم ذلك؛ فإنهم
لم يلتفتوا إلى فرنسا حين قرروا البحث عن بديل للفاغنر الروسي؛ بل ولوا
وجوههم شطر تركيا هذه المرة. وهي رسالة أخرى إلى فرنسا أنهم بالقدر ما
يبحثون عن حليف لنظامهم يبحثون عن أعداء فرنسا/نظام ماكرون.
مع أن المشكل المالي الفرنسي بدأ مشكلا عرضيا، ليس عميقا؛ دولة تسعى إلى
المحافظة على الشرعية، وانقلابيون يسعون إلى توطيد نظامهم، وكان لفرنسا
ومالي أن لا يقطعوا شعرة معاوية في علاقتهم، بحيث تكون مراكب العودة
جاهزة أي لحظة؛ فإن ذلك لم يحدث؛ وهو ما يجعل الماليون -بما فيهم رافضي
الانقلاب- يحملون فرنسا مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع في بلدهم؛ وما يعيشه من
أزمات اقتصادية وأمنية وتنموية؛ بمعنى أن أزمة العلاقة المالية الفرنسية قابلة
للتطور من أزمة تكتيكية مع النخبة العسكرية، إلى أزمة استراتيجية مع النخبة
والشعب عموما، ويترجح هذا الرأي بالوقت؛ وبالأخص حين يتم التواصل الفني
والتجاري و الثقافي مع حلفاء آخرين؛ وبالذات الحليف التركي؛ الذي يلعب على
وتر الدين، ويسوق أن تركيا ومالي يجمعهم سياق ثقافي-ديني واحد.. إن الوقت
في هذه الأزمة ليس لصالح فرنسا؛ حتى وإن كانت مآلاته -أيضا- ليست لصالح
مالي.
السنغال: قلوب مع فرنسا وسيوف ضدها:
من المعروف أن العلاقة السنغالية الفرنسية تمتاز بطابع خاص، يختلف كليا عن
علاقة فرنسا ببقية مستعمراتها الغرب أفريقية؛ إنها علاقة تتجاوز النخبة إلى
عموم الشعب. غالبية السنغاليين ينظرون إلى فرنسا أما وأباً لهم؛ تماما مثلما يرى
العديد من الفرنسيين أن دكار هو الطبعة الأفريقية الناصعة من باريس.
هذا الواقع يشهد له التاريخ السياسي السنغالي؛ خصوصا التاريخ الانتخابي؛ حيث
كان جل الساسة السنغاليين يتبارون في القرب من فرنسا والعلاقة بها؛ بل أكثر
من ذلك؛ كانت الحظوة في النفوذ في السنغال يحددها مستوى العلاقة بدوائر
القرار في باريس، ولقد ظلت هذه الأدبيات سائدة في السنغال؛ من أيام الراحل
ليبولد سيدار سينغور إلى نهاية أيام ماكي سال.. كانت الدعوة ضد فرنسا نشازا
في الخطاب السياسي السنغالي، وكان الرئيس السنغالي ما إن ينتخب حتى يشد
الرحال إلى “الإيليزيه” إنها علاقة تتجاوز الأبعاد الاقتصادية والسياسية
والعسكرية.. حيث تتربع الاستثمارات الفرنسية على لائحة المستثمرين في
السنغال، وحيث إن الساسة السينغاليين يبدؤون تكوينهم السياسي من تاريخ
“فينسنت أوريول” و”شارل ديغول” و”فرانسوا ميتران” و”جاك شيراك”.. وحيث
إن قواعد الجيش الفرنسي منتشرة بالسنغال واتفاقيات الدفاع المشترك سارية..
تتجاوز العلاقة كل تلك الأبعاد؛ إلى العلاقة الثقافية؛ إذ يفكر السنغاليون بذات
الطريقة التي يفكر بها الفرنسيون، كما يحلمون ويضحكون بذات الطريقة.
إنها علاقة عميقة، ولا يمكن التأثير عليها دون أسباب واضحة، وتراكم جلي؛
فكيف وقع ذلك؟
لقد استطاع الشاب السنغالي عثمان سونوغو (رئيس الوزراء الحالي) أن يخلق
في ظرف وجيز، بالمقارنة مع عمره السياسي، خطابا سياسيا ينتمي للسنغال
ومشاغل المواطن السنغالي البسيط؛ ولم يكن يعبأ بالواقعية في ذلك الخطاب، ولا
بالموضوعية حتى! كان همه أن يحشد بجنبه أكبر كم من السنغاليين؛ من هنا تكلم
عن الفساد وعن الإقصاء وعن عدم استقلالية القضاء، وعن حيف اتفاقيات
الشراكة مع الجهات الأجنبية؛ ليتكلم بعد كل هذا عن العلاقة غير المتكافئة مع
فرنسا، ورغم أن “سونوغو” خريج مدارس فرنسية (بمفهوم ما) ويتكلم لغة
فرنسية سليمة، وكتب بها أكثر من كتاب.. ورغم أنه ينتمي لأقلية، تعتبر من أكثر
الإثنيات السنغالية صلة وعلاقة بالفرنسيين والثقافة الفرنسية؛ رغم ذلك كله تبنى
هذا الخطاب، غير الودي بداية، والمتصادم نهاية، مع فرنسا، ولقي آذانا صاغية،
وتعمق لديه أكثر، بعد سكوت فرنسا على التضييق على المعارضة السنغالية،
وعلى محاولات ماكي سال الانقلاب على الدستور السنغالي.
وفي ذات الوقت؛ كان عثمان سونوغو يتابع عن كثب، وعن توجس، تغول
الخطاب اليميني الأوربي عموما، والفرنسي خصوصا. يرى البعض -كذلك- أنه
من رافعات هذا الخطاب ودعائمه التزام سونوغو الديني؛ الذي يذهب به البعض
أكثر من ذلك؛ حيث يرى بعض متابعي الشأن السنغالي أن عثمان سونوغو ليس
فردا مسلما فحسب؛ بل إنه إسلامي يؤمن بفكر الإسلام السياسي، وتعززت هذه
الرؤية أكثر من خلال مظهر رفيق دربه باسيرو ديوماي فاي (الرئيس السنغالي
الحالي) الذي يظهر ملتزما دينيا التزاما مبالغا فيه.
لقد صفق الكثير من السنغاليين على أنغام انتقاد فرنسا، وهو ذات النغم الذي
صوتت له منهم قرابة الستين في المائة؛ وهو ما يبعث برسالة قوية إلى فرنسا
أنها مطالبة بمصالحة مع الرأي العام السنغالي. إن رسالة السنغاليين إلى فرنسا
أعمق من رسالة الماليين؛ إنها رسالة من نخبة سياسية نزيهة حمّلتها إياها أغلبية
شعب واع ويعرف ما يريد.. السنغال هي الدولة الغرب أفريقية الوحيدة التي لم
تعرف انقلاباً، وكان جيشها جيشا جمهوريا دائما.. فهل تعي فرنسا الرسالة،
وتدرك أن قدمها في أفريقيا لا يثبتها لها إلا الشعوب؛ ومن ثم تؤسّس لمقاربات
تشاركية جديدة لا تعتمد اعتمادا مطلقا على النخبة؛ وإنما تضع اعتباراً للشعوب،
خصوصا أن العديد من هذه الشعوب ينظر إلى فرنسا باعتبارها شعلة للحضارة
والمدنية ومركزا للديمقراطية والحرية.. إن رسالة صناديق اقتراع السنغاليين يوم
24 مارس 2024 كان جلية وواضحة.